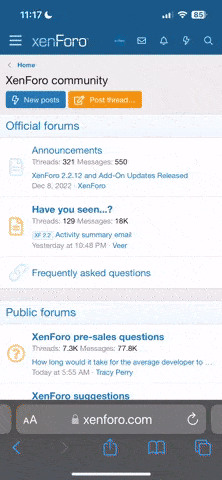رجل فكر وإصلاح بين (تأليف الرجال)
وتأليف الكتب!
وتأليف الكتب!

على أرض (الجزائر) المجاهدة وهي تقاوم الدنس الاستعماري الأوروبي (1830-1962م) ولد في الرابع من شهر ديسمبر سنة (1889م) رجل فكر وتعليم وإصلاح، ونضال في ذلك، حيث عاش وكافح بمختلف الأسلحة الفكرية، على كل الجبهات، بكل ما أوتي من قوّة، وإمكانيات، في التعليم، والمحاضرات العامة، في المدن، والقرى، وبالكتابة المستميتة الصامدة..
في الصحافة العربية الحرة العنيدة في الجزائر الصامدة، خصوصاً منها صحيفته (الشهاب) التي انطلقت جريدة، ثم صارت مجلة شهرية، إلى جانب جريدة (البصائر) التي أفلحت مع (الشهاب) في اختراق الحصار الاستعماري، لتنقل (صوت الجزائر) النضالي إلى أرجاء (الوطن العربي) و(العالم الإسلامي) مروراً بأرض الكنانة (مصر) عبر (تونس) الخضراء، وصولاً إلى (دمشق الفيحاء) وسواها، مما كان يجد صداه في صحافة تلك الأقطار نفسها.
هو الشيخ عبد الحميد بن باديس (1889-1940م) أول رئيس لأول جمعية إسلامية وطنية عربية حرة: أسست لحماية الهوية القومية للجزائر: عروبة وإسلاماً، هي (جمعية العلماء المسلمين الجزائريين) التي أسست سنة (1931م) في ظروف وطنية واستعمارية متوترة جداً.
وأسرة (ابن باديس) من أهم الأسر في هذه (القبائل) التي سميت (أمازيغية) أو (بربرية) هو من قبيلة (صنهاجة) البربرية التي إن شك بعض في أصولها العربية، وشكك آخرون فيها، فقد جعلها (الإسلام) في الواقع المحسّن: عربية عروبية فاعلة، أنجبت للعروبة والعربية والإٍسلام أعلاماً في السياسة سيروا الحكم في إمارة (صنهاجة) وغيرها، كما أنجبت أعلاماً في الفكر العربي الإسلامي، وفي الشعر العربي، وفي الفقه والشريعة، والنحو الذي اشتهر فيه أعلام، منهم: (ابن معطي) صاحب (الألفية) التي سبقت (ألفية ابن مالك) و (ابن أجروم) الصنهاجي بمصنّفه النحوي الذائع الصيت (الأجرمية) الذي استمر مقرّراً في معظم المؤسسات التعليمية العربية –الإسلامية، خصوصاً بالمغرب العربي؛ والمشرق، بما في ذلك (الزيتونة) و(القرويين) مغربياً، و(الأزهر) مشرقاً، فضلاً عن المدارس الرسمية الحكومية نفسها، في بعض هذه الأقطار وسواها.
من رحم قبيلة (صنهاجة) البربرية هذه في (الجزائر) ولد (عبد الحميد بن باديس) بمدينة (قسنطينة) في أسرة ذات ثراء وجاه ومكانة اجتماعية مرموقة، فأعرض عن ذلك: إلى طلب العلم في بلده، ثم في تونس، معزّزاً عمله بتكوين عصامي فذّ، متلمسّاً في الوقت نفسه مواطن الداء في مشاكل أمته الصغرى (الجزائر) وأمته الكبرى (العربية) والأخرى الأكبر (الإسلامية) في قراءته، وفي أسفاره إلى (تونس) طالباً أولاً، ثم محاضراً، ورحالة، وإلى (الحجاز) حاجاً رحالة متلمّساً أحوال الناس، وإلى (باريس) ينقل مطالب (الجزائريين) مع غيره، في (وفد إسلامي) زاهداً خلال ذلك كله في متاع الحياة الدنيا، متفرغاً للهمّ الجزائري وامتداداته العربية والإسلامية عموماً، معلناً في مناسبات عديدة: إن (لنا وراء هذا الوطن العزيز أوطاناً أخرى لنا هي منا على بال) هي (أوطاننا العربية والإسلامية) نعمل لها، كما نعمل لوطننا الأصغر، أو بعملنا لوطننا الأصغر نكون قد عملنا لها، لحريتها، وسؤددها، ورفعتها، فالهم واحد، والمصير مشترك.
نكران الذات في نضال (ابن باديس) وإخلاصه في عمله، وصدقه في القول والفعل مما أسهم في حشد الجزائريين حوله خصوصاً، وحول "جمعية العلماء المسلمين الجزائريين" عموماً، بعدما تأسست في (5/5/1931) فرشحه رجالها المؤسسون معه تلقائياً، وانتخبوه بالإجماع رئيساً لها، ليبدأ معركته الكبرى من البداية متنقلاً في أرجاء الوطن، معرّفاً بأهدافها، داعياً إلى العمل واليقظة فيه، في مواجهة قوى البغي والفساد، والطغيان المحلي والاستعماري من دون سهو عن أعداء العروبة والإسلام خارج الجزائر، في الوطن العربي خصوصاً، الخاضع للهيمنة، والكيد والابتزاز.
في (الجزائر) خاض معاركه الضارية جداً، في حلقات التعليم المسجدي، وفي المدارس الحرة التابعة لجمعية العلماء، وفي خطبه النارية، في (النوادي) وحتّى في المستودعات الكبرى (الفاراجات) والأسواق، والساحات العمومية، وسواها، مثل دور (السينما) و(المحلات التجارية) التي تستحيل نوادي عامرة بشؤون الفكر والإصلاح.
هذا فضلاً عن مقالاته الصحفية، الأسبوعية والشهرية، معرّضاً بأعوان الاستعمار وعملائه، حتى من أولئك الذين يرتدون رداء الدين في (الزوايا) وسواها، ليمكّنوا للاستعمار، وليسهّلوا عليه إبقاء الشعب الجزائري في خانة التخلف، مواجهاً الاحتلال الفرنسي بلغة السياسة تارة، وبلغة المنطق أخرى، وبلغة العنف عند الضرورة، وكلّ همّه حتى (آخر نفس) عزّة (الجزائر) و(العروبة) وهو القائل نظماً:
فإذا هلكت فصيحتيتحيا الجزائر والعرب
شعب الجزائر مسلموإلى العروبة ينتسب
من قال حاد عن أصلهأو قال مات فقد كذب
وكان مرور الشهور والسنين يسهم في شحذ همته أو تصعيد لغة العنف على لسانه وقلمه، فتزداد مواقفه صلابة، وحججه قوة في إفحام الخصوم، رافضاً المساومة والمهادنة، للاستعمار الذي لم يغفر له ذلك، حتى لحظة وفاته –رحمه الله- يوم (16/4/1940م) وهي وفاة تبقى الشكوك قائمة حول يد الاستعمار الملوثة بالعار، خصوصاً أن الرجل فكر في استغلال ضعف (فرنسا) أمام (ألمانيا) في تلك الحرب العالمية الثانية؛ ليخطو خطوة أخرى حينئذ على درب تحرير (الجزائر) وهي الخطوة التي حال دونها الأجل فنفذها جيل أعدّه الرجل في المدارس الحرة، وفي الحلقات المسجدية، وفي النوادي والأسواق ذاتها، ففجّر هذا الجيل ثورة العرب والمسلمين الكبرى، أعظم ثورة وطنية شعبية في القرن العشرين بروح عربية إسلامية، أعلنت في الفاتح من نوفمبر (1954م) على أرض (الجزائر) العربية الإسلامية! التي عرفت عبر تاريخها الطويل مختلف المكائد والفتن لكنها صمدت وكافحت ولم تهن.
لقد سئل هذا المعلم الجزائري، المفكر، وأستاذ الجيل رجل الإصلاح عبد الحميد بن باديس يوماً عن عدد الكتب التي ألفها؛ فأجاب ببداهة تامة: لقد شغلني "تأليف الرجال عن تأليف الكتب" فكان ردّه صدى لشحنة المعاناة، وخلاصة التجربة المضنية، وروح المهمة التي وهب نفسه لها نحو سبع وثلاثين سنة جندياً من جنود الكلمة كتابة وتعليماً.
لقد سخّر الرجل حياته كلها لوطنه (الجزائر) وخدمة أمته العربية والإسلامية؛ فمنذ فرغ من مرحلة الطلب في (جامع الزيتونة) بتونس انطلق مبكّراً من هناك يخوض غمار العمل الوطني والقومي في (التعليم) وفي (الصحافة) وفي (الخطابة)، ولم يكد يعود إلى (الجزائر) ويفرغ من أداء فريضة الحجّ حتى غرق في (الميدان) مستميتاً موصلاً ليله بنهاره، في معركة ضارية حتى آخر نفس من حياته، في آخر لحظة من آخر يوم فيها (16/4/1940) والعالم على كفّ (عفريت).
فكان المربي الفذّ (التربوي) الصادق المخلص، العالم النزيه الذي يربّي الأجيال بسلوكه وفكره وآرائه وعلمه، كلها، متكاملة مجتمعة، حتى بات قدوة المعلم ذي الضمير الحيّ، والفكر المستنير، والفكر الثاقب، والطموح القومي المتوثّب: سياسياً، ودينياً، وثقافياً، واجتماعاً.
كما كان في الوقت نفسه الإمام المسجدي المرشد، والواعظ الذي تنفذ كلماته في القلوب والعقول؛ فتستقرّ، فتورق، تثمر، مثلما كان الكاتب الصحفي (المهني) الأصيل، الذي يلوذ بقلمه كلما جنّ الليل، وفرغ من واجبات التدريس للصغار وللشباب نهاراً، وللعمال الكهول ليلاً، والصلاة والوعظ خلال ذلك ليفرغ –وقد هدأت الحياة في الخارج- لتدبيج مقالاته، في شؤون الفكر والسياسة والثقافة والدين، وقضايا المجتمع، لترى تلك المقالات طريقها –عاجلاً أو آجلاً- إلى الجريدة، جريدته (السنة) أولاً، و(الشهاب) بعدها، أو جريدة (جمعية العلماء) الأسبوعية (البصائر) أو غيرها، حتى الساعات المتأخرة من الليل، ليأوي إلى فراشه، في انتظار (الفجر) الوشيك أحياناً، لحظة استئناف الحياة التي يفتتح نهاره فيها: إماماً في المسجد ومعلماً، فتنطلق دروسه بعد صلاة (الصبح) مباشرة.
وفضلاً عن نهوضه الشخصي بالتعليم فكان يقوم إلى جانب ذلك بمتابعته المباشرة وغير المباشرة لعمل رجال التربية والتعليم الذين تعيّنهم (جمعية العلماء المسلمين الجزائريين) في مدارسها الحرة، كما يحرص على تعيين بعض تلاميذه المتفوقين مساعدين له، في الدروس المسجدية، وفي بعض مدارس الجمعية الهامة، مثل (مدرسة التربية والتعليم) في (قسنطينة).
وكلمتا (تربية) و(تعليم) كان لهما في الثلاثينيات دويّ كبير، ليس لمضمونها التربوي الديني التهذيبي التعليمي فحسب، بل لإشعاعهما القومي الوطني النضالي، تمكيناً للغة القرآن، ورفضاً لسياسة (الفرنسة) و(التشويه) وتشبثاً بالوطن وازدراء لمنطق الاندماج، إدماج الجزائريين في (المنظومة الفرنسية) هوية وثقافة، وسياسية.
لقد عزف الرجل عن مباهج الحياة في أسرته الثرية ذات الموقع الاجتماعي المتميز: بتاريخها وبمكانتها، وقرّر أن يزهد في (الحياة الزوجية) نفسها التي لم تعد تجد لها موقعاً في وقته المزدحم، بالعمل التعليمي والاجتماعي والصحفي، والإصلاحي، وأن يتفرّغ لما وهب له نفسه، متموقعاً في عدة جبهات.
فزيادة على الجبهة التعليمية: هناك الجبهة الثانية المكمّلة، هي جبهة العمل الاجتماعي والصحفي، فرأى من الضرورة العاجلة التصدّي لبعض (الآفات الاجتماعية) المستشرية في المجتمع أو التي شرعت تستشري فيه يومئذ، بحكم ضعف في الوازع الديني، أو نقص في العلم بأوامر الدين ونواهيه، أو ضعف الوعي الاجتماعي الذي يزدهر معه الدجل؛ فتسهل مهام الدّجالين في الدين، وفي السياسة، وفي الحياة العامة، حيث خاض الرجل جولات حامية الوطيس على مختلف الجبهات، مع سياسيين جهلة، دجّالين، منفصلين عن (أمتهم) و(وطنهم) فكرياً ووجدانياً، فضلاً عن مواجهته مع بعض من السياسيين فرنسيين، أو أقطاب فكر سياسي استعماري.
كما كانت معركته الطاحنة فعلاً –وإلى جانبه زملاء له- في مواجهة المشعوذين من أدعياء الدين المتاجرين به- وقد عادوا اليوم أكثر وقاحة من ذي قبل- وهم الذين اتخذوا الدين مظلة لنشر الدجل والشعوذة باسمه، يسخّرهم الاستعمار ليمكنّوا له بشتى الأساليب، كزرع روح التواكل، والقنوط، وإعلان الركون له، لكونه "قدراً" أراده الله، والله وحده يدفعه، من دون أدنى إرادة للمواطن ليغير ما بنفسه كي يمدّه الله بعونه منه، وتزعّم بعض (أعلام) من رجال (الزوايا) يومئذ هذا التيار، تيار الدروشة، فناهضوا (الفكر الإصلاحي) الحديث الذي كان يقوده (ابن باديس) فتآمرت (الزاوية العليوية) حتى على قتل الرجل، فسخّرت أحد (عملائها) الجهلة ليعترض بخنجره (ابن باديس) فجراً حين خروجه إلى (المسجد) لكن (العميل الجاهل) ما كاد يهمّ بتصويب خنجره للشيخ حتى شلّت يده، فسقطت أداة الجريمة من يده، فحق لشاعر المغرب العربي (محمد العيد) أن يقول يومئذ: "حمتك يد المولى وكنت بها لأولى"
وما كان من (ابن باديس) في النهاية إلا أن عفا عن المجرم، بروحه السمحة، في محيط كان الفكر الإصلاحي فيه يحقق انتصارات ملحوظة، فيقتطع من (الدجل) و(الدجالين) مساحات شاسعة، ويسترد (قطعاناً) بشرية سرعان ما تحوّلت إلى (نار) في وجوه الأعداء، ونور في جبين الوطن.
كان الطريق إلى ذلك الدروس والمقالات الصحفية، والخطب المسجدية، وحتى خطب الأسواق العامة، والمحلات التجارية الخاصة، حيث كان (ابن باديس) يقوم دورياً بجولات في مختلف أنحاء الوطن، فيتجه: مرة إلى شرق الوطن، وتارة إلى غربه، وتارة أخرى إلى الشمال أو إلى الجنوب، ويختار لذلك غالباً يومي العطلة التعليمية، أي بعد الفراغ من التدريس، في المساجد والمدارس العربية الحرّة، (الخميس والجمعة) أما العطلة الحكومية (الاستعمارية فهي السبت والأحد).
فكان الرجل يخطب في (التجمعات) في الأسواق الشعبية، وفي المحلاّت التجارية الكبرى، والمستودعات (الفاراجات) وحتى في (الدكاكين) العادية فضلاً عن المساجد الحرة، والحكومية التي يرخص له أحياناً بالحديث فيها بتدخل مسؤولين جزائريين في السلطة الاستعمارية.
يلاحظ القارئ الكريم: كم نوّع (ابن باديس) في أسلحته (تعليماً مدرسياً ومسجدياً، وصحافة، وخطابة، وجولات أسبوعية) كما اخترق معظم المواقع لخوض معركته، منوّعاً في المكان، حتى صارت (الدكاكين) الصغيرة تتوقف ساعات عن صرف (دقيق) و(عدس) و(قهوة) و(سكر) لزبائنها، لتصرف مجاناً إلى العقول والقلوب الفكر الوطني الإصلاحي المتوثب، فلا يخرج المواطن من الدكان بعلبة (طماطم) أو (مقارونة)، بل بشحنة معنوية هائلة من متفجرات خارقة للأعداء والعملاء، ومن تلك الشحنات وغيرها: جاء ميلاد ثورة التحرير في فجر (أول نوفمبر 1954م).
ألم يصب الرجل إذن الحقيقة حين قال: شغلني "تأليف الرجال عن تأليف الكتب؟" مع ذلك، فبعض خطبه، ومقالاته ودروسه التي لا تزال تجمع وتطبع تكوّن مجموعة مجلّدات تحوي سائر القضايا التي تطرقنا إلى بعض منها هنا على عجل، أو لمّحنا إلى بعضها تلميحاً سريعاً، لمقتضى المقام.
فهل لنا أن ننتظر من رجال التربية والتعليم في وطننا العربي اليوم أن يكونوا (مؤلفي رجال) و(كتب) معاً؟ أم سيبقون باعة (كلمات ميتة) بطبشور أخرس، و(جامعي نقود) و(نفوذ) و(وجاهة) وحائزي (مغاني) و(شقق) و(ضيعات) في كل الأوقات؟ مكتفين في النهاية! بأشكال من (سبات) والعالم ينطلق بعيداً عنّا (مسافات) بالزمن الضوئي. لا بالحساب الرقمي؟!
فسلام عليهم ما جدّوا مخلصين، و(الله أكبر).. إن مضينا متواكلين متخاذلين.. بين أوطاننا ضائعين متنابذين.